وقوله تعالى: { مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ } فهذا مما
كانت العرب أيضا في الجاهلية (1) تحرمه، وهو الذي كان عليه جمهورهم، إلا طائفة
منهم يقال لهم: "البَسْل"، كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهر، تعمقا
وتشديدًا.
وأما قوله: "ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة
والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، [فإنما أضافه إلى مضر، ليبين صحة قولهم
في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان] (2) لا كما كانت تظنه ربيعة من أنَّ رجب
المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال، وهو رمضان اليوم، فبين، عليه [الصلاة و] (3) السلام، أنه رجب
مضر لا رجب ربيعة. وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة، ثلاثة سَرْدٌ وواحد فرد؛ لأجل
أداء مناسك الحج والعمرة، فحرم قبل شهر الحج شهر، وهو ذو القعدة؛ لأنهم يقعدون فيه
عن القتال، وحُرِّم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء
المناسك، وحرم بعده شهر آخر، وهو المحرم؛ ليرجعوا فيه إلى نائي أقصى بلادهم آمنين،
وحرم رجب في وسط الحول، لأجل زيارة البيت والاعتمار به، لمن يقدم إليه من أقصى
جزيرة العرب، فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا.
وقوله تعالى: { ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ } أي: هذا هو الشرع
المستقيم، من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم، والحَذْو بها على ما سبق
في كتاب الله الأول.
وقال تعالى: { فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ }
أي: في هذه الأشهر المحرمة؛ لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في
البلد الحرام تضاعف، لقوله تعالى: { وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ
نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } [الحج: 25] وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام؛
ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي، وطائفة كثيرة من العلماء، وكذا في حَقِّ من
قتل في الحرم أو قتل ذا محرم.
وقال حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مِهْران،
عن ابن عباس، في قوله: { فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ } قال: في الشهور
كلها.
وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: { إِنَّ
عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا } الآية { فَلا
تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ } في كلِّهن، ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن
حراما، وعَظم حُرُماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم.
وقال قتادة في قوله: { فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ
أَنْفُسَكُمْ } إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرًا، من الظلم فيما سواها،
وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. قال: إن الله
اصطفى صَفَايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا واصطفى من الكلام
ذِكْرَه، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم،
__________
(1) في ت، ك، أ: "جاهليتها".
(2) زيادة من ت، أ.
(3) زيادة من ت، أ. /(4/148)
واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة
القدر، فَعَظِّموا ما عظم الله، فإنما تُعَظم الأمور (1) بما عظمها الله به عند
أهل الفهم وأهل العقل.
وقال الثوري، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن
الحنفية: بألا تحرموهن كحرمتهن (2)
وقال محمد بن إسحاق: { فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ
أَنْفُسَكُمْ } أي: لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما، كما فعل أهل الشرك،
فإنما النسيء الذي كانوا يصنعون من ذلك، زيادة في الكفر { يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ
كَفَرُوا } الآية [التوبة: 37].
وهذا القول اختيار ابن جرير.
وقوله:
{ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً } أي: جميعكم (3)
{ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً } أي: جميعهم، { وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
مَعَ الْمُتَّقِينَ }
وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر
الحرام: هل هو منسوخ أو محكم؟ على قولين:
أحدهما -وهو الأشهر:
أنه منسوخ؛ لأنه تعالى قال هاهنا: { فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ } وأمر بقتال المشركين وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمرًا عاما، فلو كان محرما ما في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها؛ ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام -وهو ذو القعدة -كما ثبت في الصحيحين: أنه خرج إلى هوازن في شوال، فلما كسرهم واستفاء أموالهم، ورجع فَلُّهم، فلجئوا إلى الطائف -عَمد إلى الطائف فحاصرها أربعين يوما، وانصرف ولم يفتتحها (4) فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام.
والقول الآخر: أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام،
وأنه لم ينسخ تحريم الحرام، لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا
تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ } [الآية] (5) [المائدة: 2 ]
وقال: { الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ } الآية[البقرة: 194] وقال: { فَإِذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ } [الآية]
[التوبة: 50] (6)
وقد تقدم أنها الأربعة المقررة في كل سنة، لا أشهر
التسيير على أحد القولين.
وأما قوله تعالى: { وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً
كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً } فيحتمل أنه منقطع عما قبله، وأنه حكم مستأنف،
ويكون من باب التهييج والتحضيض، أي: كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم
أيضا لهم إذا حاربتموهم، وقاتلوهم بنظير ما يفعلون، ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال
__________
(1) في ت، أ: "يعظم من الأمور".
(2) في ت: "لحرمتهن".
(3) في ت: "جميعهم".
(4) في ت: "يفتحها".
(5) زيادة من ت، ك، أ.
(6) زيادة من ت، ك، أ. /(4/149)
المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم، كما
قال تعالى: { الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ
} [البقرة: 194] وقال تعالى: { وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ }
الآية[البقرة: 191] ،
وهكذا الجواب عن
حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف، واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر
الحرام، فإنه من (1) تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف، فإنهم هم الذين ابتدءوا
القتال، وجمعوا الرجال، ودعوا إلى الحرب والنزال، فعندما قصدهم رسول الله صلى الله
عليه وسلم كما تقدم، فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم، فنالوا من
المسلمين، وقتلوا جماعة، واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريبا من أربعين يوما.
وكان ابتداؤه في شهر حلال، ودخل الشهر الحرام، فاستمر فيه أياما، ثم قفل عنهم لأنه
يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وهذا هو أمر مقرر، وله نظائر كثيرة،
والله أعلم. ولنذكر الأحاديث الواردة في ذلك (2) وقد حررنا ذلك في السيرة، والله
أعلم (3)
__________
(1) في ت، أ: "في".
(2) كذا ولم أجد شيئا من ذلك، ورفع في هـ، ك فراغ قدر
أربعة أسطر، ووصل الكلام في باقي النسخ.
(3) في ك: "والحمد لله". /(4/150)
إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ
بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا
لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ
زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ (37) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ
انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي
الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ
أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ
يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ
سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ
الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40)
التوبة - تفسير ابن كثير
إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ
بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا
لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ
زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ (37)
{ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ
بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا
لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ
زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
(37) }
هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع
الله بآرائهم الفاسدة، وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة، وتحليلهم ما حرم
الله وتحريمهم ما أحل الله، فإنهم كان فيهم من القوة الغضَبِية والشهامة والحمية
ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال
أعدائهم، فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفر، فيحلون
الشهر الحرام، ويحرمون الشهر الحلال، ليواطئوا عدة الأشهر الأربعة (1) كما قال
شاعرهم -وهو عمير بن قيس المعروف -بجذل الطعان:
لَقَدْ عَلمت مَعد أنَّ قَومِي ... كرَامُ النَّاس أنَّ
لَهُمْ كِراما ...
ألسْنا الناسئينَ على مَعد ... شُهُورَ الحِل نَجْعلُهَا
حَرَاما ...
فأيّ النَّاسِ لَم تُدْرَك بوتْر? ... وأيّ النَّاس لم
نُعْلك لجاما? (2)
__________
(1) في ك، أ: "ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر
الأربعة".
(2) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (1/45)./(4/150)
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: { إِنَّمَا
النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ } قال: النسيء أنَّ جُنادة بن عوف بن أمية
الكناني، كان يوافي الموسم في كل عام، وكان يكنى "أبا ثُمَامة"، فينادي:
ألا إن أبا ثمامة لا يُحاب ولا يُعاب، ألا وإن صفر العام الأول حلال. فيحله للناس،
فيحرم صفرا عاما، ويحرم المحرم عاما، فذلك قول الله: { إِنَّمَا النَّسِيءُ
زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ } [إلى قوله: { الكافرين } وقوله { إِنَّمَا النَّسِيءُ
زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ } ] (1) يقول: يتركون المحرم عاما، وعاما يحرمونه.
وروى العوفي عن ابن عباس نحوه.
وقال ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، كان رجل من بني كنانة
يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له، فيقول: يا أيها الناس، إني لا أعاب ولا أجاب،
ولا مَرَدّ لما أقول، إنا قد حَرَّمنا المحرم، وأخرنا صفر. ثم يجيء العام المقبل
بعده فيقول مثل مقالته، ويقول: إنا قد حرمنا صفر، وأخرنا المحرم. فهو قوله: {
لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ } قال: يعني الأربعة { فَيُحِلُّوا مَا
حَرَّمَ اللَّهُ } لتأخير هذا الشهر الحرام.
وروي عن أبي وائل، والضحاك، وقتادة نحو هذا.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: { إِنَّمَا
النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ } الآية، قال: هذا رجل من بني كنانة يقال له:
"القَلَمَّس"، وكان في الجاهلية، وكانوا في الجاهلية لا يغيرُ بعضهم على
بعض في الشهر الحرام، يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يَمُدُّ إليه يده، فلما كان هو،
قال: اخرجوا بنا. قالوا له: هذا المحرم! قال: ننسئه العام، هما العام صفران، فإذا
كان العام القابل قضينا جعلناهما مُحرَّمين. قال: ففعل ذلك، فلما كان عام قابل
قال: لا تغزُوا في صفر، حرموه مع المحرم، هما محرمان.
فهذه صفة غريبة في النسيء، وفيها نظر؛ لأنهم في عام إنما
يحرمون على هذا ثلاثة أشهر فقط، وفي العام الذي يليه يحرمون خمسة أشهر، فأين هذا
من قوله تعالى: { يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا
عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ }
.
وقد روي عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضا، فقال عبد الرزاق،
أخبرنا مَعْمَر، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد في قوله: { إِنَّمَا النَّسِيءُ
زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ } الآية، قال: فرض الله، عز وجل، الحج في ذي الحجة. قال:
وكان المشركون يسمون الأشهر ذا الحجة، والمحرم، وصفر، وربيع، وربيع، وجمادى،
وجمادى، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوالا (2) وذا القعدة. وذا الحجة يحجون فيه مرة
أخرى ثم يسكتون عن المحرم ولا يذكرونه، ثم يعودون فيسمون صفر صفر، ثم يسمون رجب
جمادى الآخرة، ثم يسمون شعبان رمضان، ثم يسمون شوالا رمضان، ثم يسمون ذا القعدة
شوالا
__________
(1) زيادة من ت، ك، أ، والطبري.
(2) في أ: "وشوال". /(4/151)
ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة، ثم يسمون المحرم ذا الحجة،
فيحجون فيه، واسمه عندهم ذو (1) الحجة، ثم عادوا بمثل هذه القصة فكانوا يحجون في
كل شهر عامين، حتى وافق حجة أبي بكر الآخر من العامين في القعدة (2) ثم حج النبي
صلى الله عليه وسلم حجته التي حج، فوافق ذا الحجة، فذلك حين يقول النبي صلى الله
عليه وسلم في خطبته: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات
والأرض".
وهذا الذي قاله مجاهد فيه نظر أيضا، وكيف تصح حجة أبي
بكر وقد وقعت في ذي القعدة، وأنى هذا؟ وقد قال الله تعالى: { وَأَذَانٌ مِنَ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ
بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ } الآية[التوبة: 3] ،
وإنما نودي بذلك في حجة أبي بكر، فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالى : { يَوْمَ
الْحَجِّ الأكْبَرِ } ولا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذي ذكره، من دوران السنة
عليهم، وحجهم في كل شهر عامين؛ فإن النسيء حاصل بدون هذا، فإنهم لما كانوا يحلون
شهر المحرم عاما يحرمون عوضه صفرا، وبعده ربيع وربيع إلى آخر [السنة والسنة بحالها
على نظامها وعدتها وأسماء شهورها ثم في العام القابل يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه،
وبعده صفر، وربيع وربيع إلى آخرها] (3) فيحلونه عاما ويحرمونه عاما؛ ليواطئوا عدة
ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله، أي: في تحريم أربعة أشهر من السنة، إلا أنهم
تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية وهو المحرم، وتارة ينسئونه
إلى صفر، أي: يؤخرونه. وقد قدمنا الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: "إن
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا منها
أربعة حرم، ثلاثة متوالية: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر"، أي: أن
الأمر في عدة (4) الشهور وتحريم ما هو محرم منها، على ما سبق في كتاب الله من
العدد والتوالي، لا كما يعتمده جهلة العرب، من فصلهم تحريم بعضها بالنسيء عن بعض،
والله أعلم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا صالح بن بشر بن سلمة الطبراني،
حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه
قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة، فاجتمع إليه من شاء الله من
المسلمين، فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل (5) ثم قال: "وإنما النسيء من
الشيطان، زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما".
فكانوا يحرمون المحرم عاما، ويستحلون صفر (6) ويستحلون المحرم، وهو النسيء (7)
وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب
"السيرة" كلامًا جيدًا ومفيدًا حسنًا، فقال: كان أول من نسأ الشهور على
العرب، فأحل منها ما حرم الله، وحرم منها ما أحل الله، عز وجل،
"القَلمَّس"، وهو: حذيفة بن عبد مُدْرِكة فُقَيم (8) بن عدي بن عامر بن
ثعلبة بن الحارث بن مالك بن
__________
(1) في ك: "ذا".
(2) في ك، أ: "ذي القعدة".
(3) زيادة من ت، ك، أ.
(4) في ت: "هذه".
(5) في ت، أ: "بما هو أهله".
(6) في ت، ك، أ: "صفر منه".
(7) ورواه أبو الشيخ الأصبهاني كما في الدر المنثور (5/188).
(8) في ت، ك، أ: "عبد بن فقيم". /(4/152)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ
لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39)
كنانة بن خُزَيمة بن مدْرِكة بن إلياس بن مُضَر بن نزار
بن مَعدَّ بن عدنان، ثم قام بعده على ذلك ابنه عَبَّاد ثم من بعد عباد ابنه قَلَع
بن عباد، ثم ابنه أمية بن قلع، ثم ابنه عوف بن أمية، ثم ابنه أبو ثمامة جنادة بن
عوف، وكان آخرهم، وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه،
فقام فيهم خطيبًا، فحرم رجبا، وذا القعدة، وذا الحجة، ويحل المحرم عاما، ويجعل
مكانه صفر، ويحرمه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله، يعني: ويحرم ما
أحل الله.
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا
قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأرْضِ
أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ (38) إِلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) }
هذا شروع في عتاب من تخلَّف عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم في غزوة تبوك، حين طابت الثمار والظلال في شدة الحر وحَمَارَّة (1) القيظ،
فقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ
انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } أي: إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله {
اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأرْضِ } أي: تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة والخفض وطيب
الثمار، { أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ } أي: ما لكم فعلتم (2) هكذا أرضا منكم
بالدنيا بدلا من الآخرة
ثم زهد تبارك وتعالى في الدنيا، ورغب في الآخرة، فقال: {
فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ } كما قال الإمام
أحمد.
حدثنا وَكِيع ويحيى بن سعيد قالا حدثنا إسماعيل بن أبي
خالد، عن قيس، عن المستَوْرِد أخي بني فِهْر قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل إصبعه هذه في اليم، فلينظر بما
ترجع؟ (3) وأشار بالسبابة.
انفرد بإخراجه مسلم (4)
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا بشر بن مسلم بن (5) عبد الحميد
الحِمْصي، حدثنا الربيع بن رَوْح، حدثنا محمد بن خالد الوهبي، حدثنا زياد -يعني
الجصاص -عن أبي عثمان قال: قلت: يا أبا هريرة، سمعت من إخواني بالبصرة أنك تقول:
سمعت نبي الله يقول: "إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة" قال أبو
هريرة: بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله يجزي بالحسنة
ألفي ألف
__________
(1) في أ: "وحماوة".
(2) في ت، ك، أ: "صنعتم".
(3) في أ: "يرجع".
(4) المسند (4/228) وصحيح مسلم برقم (2858).
(5) في أ: "عن". /(4/153)
إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ
أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ
لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ
كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (40)
حسنة" ثم تلا هذه الآية: { فَمَا مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ } (1) (2)
فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل.
وقال [سفيان] (3) الثوري، عن الأعمش في الآية: { فَمَا مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ } قال: كزاد الراكب.
وقال عبد العزيز بن أبي حازم (4) عن أبيه: لما حضرت عبد
العزيز بن مروان الوفاةُ قال: ائتوني بكفني الذي أكفن فيه، أنظر إليه (5) فلما وضع
بين يديه نَظَر إليه فقال: أمَا لي من كَبِير (6) ما أخلف من الدنيا إلا هذا؟ ثم
ولى ظهره فبكى وهو يقول أفٍّ لك من دار. إن كان كثيرُك لقليل، وإن كان قليلك
لقصير، وإن كنا منك لفي غرور.
ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال: { إِلا تَنْفِرُوا
يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا } قال ابن عباس: استنفر رسول الله صلى الله عليه
وسلم حيا من العرب، فتثاقلوا عنه، فأمسك الله عنهم القَطْر فكان عذابهم.
{ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ } أي: لنصرة نبيه
وإقامة دينه، كما قال تعالى: { إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ
ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ } [محمد: 38].
{ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا } أي: ولا تضروا الله شيئًا
بتوليكم عن الجهاد، ونُكُولكم وتثاقلكم عنه، { وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ } أي: قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم.
وقد قيل: إن هذه الآية، وقوله: { انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا }
وقوله { مَا كَانَ لأهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأعْرَابِ أَنْ
يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ } [التوبة: 120] إنهن منسوخات بقوله تعالى: {
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ
فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ } [التوبة: 122] رُوي هذا عن ابن عباس، وعِكْرِمة،
والحسن، وزيد بن أسلم. ورده (7) ابن جرير وقال: إنما هذا فيمن دعاهم رسول الله صلى
الله عليه وسلم إلى الجهاد، فتعين عليهم ذلك، فلو تركوه لعوقبوا عليه.
وهذا له اتجاه، والله [سبحانه و] (8) تعالى أعلم
[بالصواب] (9)
{ إِلا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ
أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ
يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزلَ اللَّهُ
سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ
الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40) }
__________
(1) في ت، ك، أ: "ما الحياة" وهو خطأ.
(2) ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، وابن مردويه
في تفسيره كما في الدر المنثور (5/193).
(3) زيادة من ت، ك، أ.
(4) في أ: "حاتم".
(5) في ت: "فيه".
(6) في ت، ك، أ: "كثير".
(7) في أ: "ورواه".
(8) زيادة من ت، أ.
(9) زيادة من ت، أ.
(4/154)
يقول تعالى: { إِلا تَنْصُرُوهُ } أي: تنصروا رسوله، فإن
الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه، كما تولى نصره { إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ
كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ [إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ] } (1) أي: عام الهجرة، لما
هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه، فخرج منهم هاربًا صحبة صدِّيقه وصاحبه أبي بكر
بن أبي قحافة، فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطَّلَبُ الذين خرجوا في
آثارهم، ثم يسيرا نحو المدينة، فجعل أبو بكر، رضي الله عنه، يجزع أن يَطَّلع عليهم
أحد، فيخلص إلى الرسول، عليه السلام (2) منهم أذى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم
يُسَكِّنه ويَثبِّته ويقول: " يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما"،
كما قال الإمام أحمد:
حدثنا عفان، حدثنا همام، أنبأنا ثابت، عن أنس أن أبا بكر
حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في الغار: لو أن أحدهم (3) نظر إلى
قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال: فقال: "يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما".
أخرجاه في الصحيحين (4)
ولهذا قال تعالى: { فَأَنزلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
عَلَيْهِ } أي: تأييده ونصره عليه، أي: على الرسول في أشهر القولين: وقيل: على أبي
بكر، وروي عن ابن عباس وغيره، قالوا: لأن الرسول لم تزل معه سكينة، وهذا لا ينافي
تجدد سكينة خاصة بتلك الحال؛ ولهذا قال: { وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا } أي: الملائكة، {
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ
الْعُلْيَا }
قال ابن عباس: يعني { كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا }
الشرك و { كَلِمَةُ اللَّهِ } هي: لا إله إلا الله.
وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه، قال:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حَمِيَّة، ويقاتل
رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في
سبيل الله" (5)
وقوله: { وَاللَّهُ عَزِيزٌ } أي: في انتقامه وانتصاره،
منيع الجناب، لا يُضام من لاذ ببابه، واحتمى بالتمسك بخطابه، { حَكِيمٌ } في
أقواله وأفعاله.
__________
(1) زيادة من ك.
(2) في ك: "رسول الله صلى الله عليه وسلم".
(3) في ت: "أحدا".
(4) المسند (1/4) وصحيح البخاري برقم (3653) وصحيح مسلم
برقم (2381).
(5) صحيح البخاري برقم (2810) وصحيح مسلم برقم (1904). ...

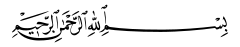
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق